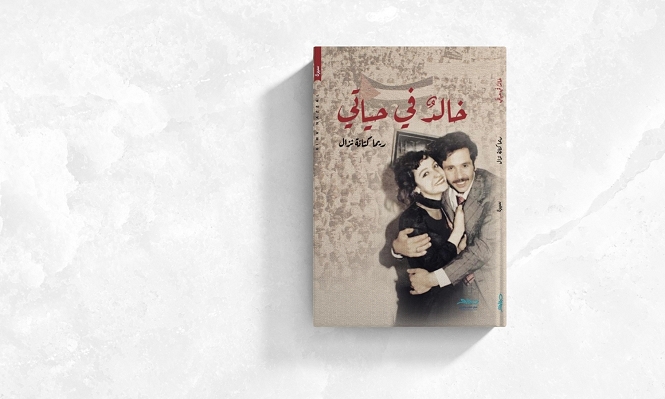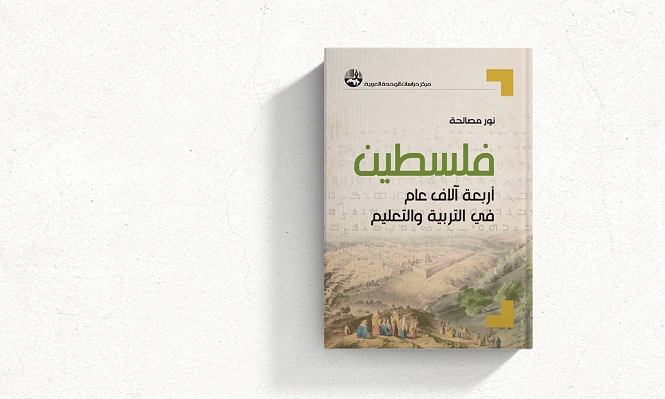بوّابة المطر | فصل

«بوّابة المطر»، مجموعة قصصيّة للكاتب الفلسطينيّ راكان حسين، صدرت أخيرًا عن مكتبة كلّ شيء في حيفا.
تنشر فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة قصّة من المجموعة بإذن من الكاتب.
.....
شتاتلوس
العلامات الثلاث في بطاقة الهويّة الألمانيّة (XXX) تستفزّني دومًا، بحثت عن معناها الحرفيّ في محرّك البحث غوغل، فظهرت أمامي رزمةٌ من الأفلام الإباحيّة، نزلتُ إلى أسفل الشاشة فوجدتُ أنّها تعني مجهول النسب أو بلا وطن.
أعدتُ السؤال على الموظّفة الشقراء عدّة مرّات، فتبرّأتْ من رأيها حول هذه الوصمة. وضعتُ أمامها كواشين ملكيّة أراضي عائلتنا في مغار حزور في فلسطين، وأعطيتها كرت الأونروا الأبيض للتأكّد من قيود ميلاد الأب والأمّ في إحدى قرى طبريّا.
في البداية تعاملتْ مع الأمر بتهذيبٍ عالٍ، وابتسامةٍ نظيفةٍ مثل المناديل المعطّرة، لكنّها سرعان ما بدأتْ تضجر من إلحاحي وأنا أتحدّث لها عن طبريّا، أخفضِ بحيرةٍ عذبةٍ على سطح الأرض… ألم تسمعي بها؟ تلك البحيرة الّتي مشى عليها المسيح، قالت:
مشى عليها أم لم يمش، هذا الأمر لا يهمّني… أستطيع أن أحدّثك لساعاتٍ عن بحيرة «البودن زي»، وكيف مشيتُ مع صديقتي بقاربنا بها لساعات، اذهب وأقنع مَنْ وضع قانون اللجوء الخاصّ بذلك. أنا مجرّد موظّفة… وأقفلتْ عليّ الكلام.
صفقتُ الباب خلفي غاضبًا وتمتمتٌ متّهمًا إيّاها بالعنصريّة. لكن سرعان ما ضحكتُ من نفسي على هذا النقاش الأحمق في غير مكانه، مع موظّفةٍ مبرمجةٍ لمساعدة الوافدين على إتمام وثائقهم لإكمال دراستهم للّغة الألمانيّة. معها حقّ، ما الفرق إن مشى على الماء بجوربيه أو بقاربٍ مطّاطيٍّ أو حتّى بالبلم! يا لغبائي!
ليس هذا فقط، بل نحن نتشارك هنا مع الغجر بطاقات الهويّة بذات الرمز «شتاتلوس Staatenlos» دون أن يتحسّسوا مثلي من الإهانة نفسها الّتي توجّه لوجودهم.

تذكّرت النَّوَرِيَّ أبو يوسف، الّذي نحت جرن القهوة من قرميّة التوت لجدّي، وكيف جاء وأقام في بلدتنا لاحقًا؛ ففي أحد الأصياف، نصب النَّوَر خيامهم دون سابق إنذارٍ على حدود المزيريب، استفقنا يومها ورأينا الخيام تشتعل بالألوان، رأينا دخانًا يتصاعد تحت قدورٍ كبيرةٍ وجلبةٍ غير معهودةٍ في أنحاء المكان… جاؤوا مع حميرهم وأولادهم ونسائهم الموشومات بالحنّاء وتركتورٍ صغيرٍ يجرّ مقطورة ماء، وموتورٍ عسكريٍّ بمقعدٍ جانبيٍّ دون لوحة. وبعد سماع الخبر، جمعتنا أمّي، أمسكتْ بيد أخي الأصغر وحذّرتنا من أن نبتعد عن حدود البيت والذهاب إلى شرقيّ الطريق حيث خيامهم، فقد أُشيع أنّهم يسرقون الأولاد الصغار، ويخبّئونهم في خروج الحمير الهزلى ويمضون بهم تحت جنح الظلام إلى أماكن بعيدة، لتعليمهم فنّ التسوّل بعد أن يصبغوا غررهم بالحنّاء.
خفتُ يومها، وبقيتُ طوال الليل أتحسّس شعري خوفًا من حنّاء قد يقع عليه وأنا نائم، وقد يدخلون علينا في أيّ لحظةٍ ليسحبونا من أيدينا كما يسحب الضبع فريسته بعد أن يرشقها ببوله.
كان الهواء الشرقيّ يأتي إلينا بروائح طيّبةٍ من الدواخين المستطيرة للخبز الصباحيّ من صوب خيامهم، وبدأت النسوة الملفّعات بأرديةٍ ملوّنةٍ طويلةٍ بالتجوّل في المحيط؛ لنَقْلِ الماء بالدلاء من بحيرة البجّة إلى المرابع الجديدة، واحتطاب أغصان الأشجار، يحزمنها ويحملنها مثل تلّةٍ صغيرةٍ فوق الرؤوس. وما إن طلعت الشمس حتّى بدأنا نستسلم ونتآلف مع هذا الموجود المباغت الّذي لا بدّ أن نعتاد عليه كما يبدو.
كنت هَلِعًا من هذه الرِّحال الّتي حطّت شرق الطريق، حيث كان ينقطع الدرب القريب من المقبرة كلّ مساء، كما تروي جدّتي لنا ذلك في خراريفها الّتي أسّست لبدايات تكوين وعي الخوف في أعماقنا، الّذي ظلّ يلازمنا في ما بعد؛ فما إن ينزل الليل حتّى تسمع همهمات وضحكات الجنّ تأتيكَ من خلف الصخور، حكاياتٍ عن جنٍّ يرجمون كلّ مَنْ يمرّ في هذا الطريق بالحجارة. وفي أوقات الشتاء القاسية تخرج الغولة من الخرائب القريبة لتسدّ درب عابري السبيل والمقطوعين. عشرات الحكايات الّتي رُوِيَت عن هذه البقعة المخيفة، وها قد جاء النَّوَر ليقيموا فوق تلّة الحكايات هذه.
مَنْ يدري؟ قد يكونون متواطئين مع الجنّ والغولة ولا يهمّهم صوت ضحكاتهم المغلّفة بالعتم، أو ربّما كانوا أقوى بأسًا منهم، فما الّذي يجعلهم يتوارون ويهربون عند مجيئهم؟
لم يكن في هواجسي ما يفرّق الجنّ عن النَّوَر، فكلاهما يبعث الرهبة الّتي تجعلني أخفي رأسي تحت الغطاء طوال الليل؛ خوفًا من متسلّلٍ يدخل حلمي أو يقرع باب بيتنا على غفلة.
سمعت أبي يقول في مجلس جدّي، إنّهم لا يقيمون فترةً طويلةً في مكانٍ واحد، هذه طباعهم، فهم يتطيّرون من المكوث الطويل.
دخل القرية عصر الذهول والسحر، حين بدأت نساؤها بحمل الأواني النحاسيّة والطناجر الصدئة إلى الطنجرليّة والمبيّضين في الخيام المزركشة، فتعود فضّيّةً لامعة... وأشرقت الأسنان الذهبيّة للعجائز والصبايا في شوارع البلدة، فكانوا يتقصّدون الابتسام على غير العادة لتظهر الضواحك المزيّنة بذهب النَّوَر.
أختي فاطمة اعتادت كلّ ليلةٍ التحديق في النجوم وعدّها، لتطمئنّ على وجودها بمواقعها المعتادة، فنالت الثآليل من جبينها جزاءً لها على مراقبتها للأرواح المعلّقة فيها، وللشهب الّتي ترجم الشياطين وهي تحاول تهكير اللوح المحفوظ ونسخ ملفّاته.
الثآليل أعجزت أمّي، وأطبّاء الأونروا، وشيخ البلدة الّذي استعان بمراجع «الطبّ النبويّ» و«فضائل الدعاء» دون جدوى. وعندما عجز، دعاها للتّحلّي بصبر المؤمن والاستغفار الدائم. لم يجد بُدًّا من تأجيل الشفاء إلى يوم القيامة واعتبرها محنةً أنزلها الله بها.
في ذلك الصباح، استفقتُ على صوت النَّوَرِيَّة أمّ مزهر وهي تجلس على مصطبة البيت، وتضع رأس فاطمة في حضنها، وتتمتم بشيءٍ مثل السحر، وهي تمسح بيدها المقشّبة جبينَها المبثور بالنتوءات الخشنة، ثمّ طلبت من أمّي مكنسةً قديمةً فكنست بها جبينها وألقتها في وقت تمام القمر بين القصب عند طرف البحيرة، لتزول الثآليل بعد أيّامٍ ويصفو وجهها دون حاجةٍ إلى استغفارٍ أو صبر. بعد ذلك صارت فاطمة تقاوم رغبتها العارمة بعدّ النجوم والنظر إلى بريقها.
دسّت أمّي حفنةً من الليرات في يدها، تناولتها أمّ مزهر وهي تبتسم وخبّأتها دون أن تعدّها في خزينة حمّالة صدرها الكبيرة.
هذه الخزينة كانت قبّعة الحاوي الّتي يدخل ويخرج منها قرودٌ مروّضة، وديكةٌ تسّبح الله بأصوات الماعز، وحِلِيٌّ تقليديّةٌ للفتيات تبيعها هنا وهناك، وعجينة الحنّاء، وحصى البصارة، مكاحل وخرزاتٌ زرقاءُ مع أكفٍّ تتوسّطها عينٌ واسعة. وصارت تتردّد على المصطبة لتجمع النساء حولها، فتفتح الفنجان وتحذرهنّ من غدر الأزواج، ومن الأفاعي الّتي تسدّ الطرق والأرزاق، والعيون الحاسدة الظاهرة على أطراف الفنجان، وتثير بهنّ الغيرة والخوف إذا ظهر خاتمٌ في قعر الفنجان، هذا يعني أنّ نيّة خطوبةٍ أو زواجٍ يُخطّطُ له في الخفاء، فأحالت أيّامهنّ إلى علقمٍ وكحل.
أمّا جدّي، فقد عقد صداقةً وثيقةً مع البيطار أبو يوسف، بعد أن رافقه إلى بيت أحد القرويّين لحذو أحد البغال، وأثناء حديثه معه اتّفقا أن ينحت له جرن قهوة.
جاء أبو يوسف ودار يتفحّص قرميّة التوت الثقيلة، حتّى اطمأنّ إلى سلامتها من الشقوق بعد أن جُفِّفَت في الظلّ حولين كاملين. وخلال فترة الإنجاز غير المتّفق عليها، بدأت أحاديث جديدةٌ تتردّد في المضافة، غير تلك الّتي اعتدنا عليها عن أيّام البلاد؛ انتصارات وبطولات جدّي وأصدقائه الّتي لا تنتهي، والّتي انتهت بهروبهم من قراهم في فلسطين... جدّي الّذي لا يتقن شيئًا سوى دقّ القهوة وتخميرها وهزّ الفنجان والحديث عن مغامراتٍ مع نساءٍ انتهى زمنهنّ، وفي كلّ مرّةٍ ينسى بعضًا من تفاصيلها وأسمائها فنكملها نحن، أو نخترع اسمًا يوافق عليه، أو يغيّر الخاتمة كما يحلو له.
البيطار أبو يوسف وأبو مزهر والرجال الشُّعّار والقواصيد، أضافوا لونًا آخر مفعمًا بالحياة لسهرات المضافة. كنتُ أنصت بملء جوارحي إلى الكلام الثريّ بالمعرفة والخبرة حول معالجة الأمراض والتداوي بالكيّ والأعشاب، وبراعتهم في الطهور ورسم الوشوم وتلبيس الأسنان وصناعة الغرابيل وحفر الخشب والبيطرة. وفي المساء يمضي رجال المضافة في إثرهم إلى الخيام المزركشة، حيث الدفوف الّتي تقرع والحَجِّيّات اللّواتي يرقصن حافياتٍ فوق التراب لترنّ الخلاخيل على السيقان البضّة، فيسيل لعاب رجال البلدة الّذين أدمنوا الذهاب يومًا بعد يوم.
في البداية لم يكن يُسْمَحُ لنا بالذهاب إلى الأخبية، لكنّ النساء الغيورات اللّواتي كنّ يلحقن بأزواجهنّ، يصطحبن أولادهنّ معهنّ، وهكذا فُتِحَ الطريق المحظور علينا. لم أصدّق ما كنت أرى!
نسيت خراريف جدّتي والجنّ الّذين يضحكون ويرجمون الناس بالحجارة، ونسيت الغولة والنَّوَر المرعبين. كان ثمّة مشهدٌ آخر غير الّذي غُرِسَ في أذهاننا.
نيرانٌ مضرمةٌ حول القدور، ومشاعل تنير الأنحاء، دقّ دفوفٍ وحَجِّيّاتٌ يلوّحن بشعورهنّ مع كلّ دقّة، وفتياتٌ بأعمارنا تنحني أمامهنّ الحدائق... كنّ جميلاتٍ مفعماتٍ بالنظرات الحارّة والابتسامات المعلنة على الملأ دون خجل، وكنّ دوعننا للرقص معهنّ. كنّ مختلفاتٍ عن فتيات الحيّ المتيبّسات كالحطب، والعابسات بوجه نظرة الحبّ، ونظرات كبريائهنّ تغرز أظافرها في وجوهنا.
النَّوَر أكثر تحررًّا وانفتاحًا من بيئتنا المغلقة، كنت مبهورًا بجمالهم ورشاقتهم وسمرتهم الهنديّة، حيث قال البيطار أبو يوسف إنّهم جاؤوا بها من بلادٍ بعيدةٍ جدًّا لم نسمع بها قطّ.
تحلّقنا حول مزهر، هذا الشابّ الجميل... عرفت في ما بعد أنّه ابن أمّ مزهر (جرس إنذار الحيّ)، فقلت له إنّ أمّي صديقة أمّه. ضحك كثيرًا وقال إنّ أمه صديقة لكلّ نساء ورجال هذا الكوكب. وبدأ يحدّثنا عن الصيّاغ الّذين يحوّلون التنك والصفيح إلى قطعٍ لامعةٍ كالفضّة، تزيّن أعناق النساء، وإلى خلاخيل تهزّ رعاش القلب في أقدامهنّ، ثمّ تحدّث كيف وصلوا في إحدى الرحلات إلى نهاية الأرض المسطّحة، حيث حافة انهدامٍ عميقٍ عليك الحذر من السقوط فيه، وكيف حوّلوا ديدان الأرض في تلك البقاع إلى فراشاتٍ كفيفةٍ تدور حول المشاعل كعقارب الساعة و تنير الفراغ.
حتّى أنّهم قاموا بمغامراتٍ مثيرة، تسلّقوا الجبال العالية، ووصلوا بسلالم من القصب إلى ثقب الأوزون...
سألته ما هو ثقب الأوزون يا مزهر؟ لكنّه لم يردّ... عرفت أنّهم أخذوا مجموعةً كبيرةً من الرقاع تكفي لإغلاق هذا الثقب، وأخذوا شخصًا بدينًا أيضًا، كان قد وعدهم بمساعدتهم بالوقوف بطريقةٍ عرضيّةٍ لسدّ تلك الثغرة إلى الأبد...
ظلّت الأحاديث تسيل على أطراف الليل من بلاد الخضرة والنساء إلى بلاد البطاريق والفقمات والجليد الّذي لا يزول، حتّى انطفأت نيران المواقد.
في تلك الليلة رفعت الغطاء عن رأسي وبدأ العالم يتّسع والفتيات يرقصن على أطرافه، رفعت الرتاج وتركت الباب مواربًا لأوّل مرّة، فلعلّ هؤلاء النَّوَر الّذين لا يمكثون طويلًا في مكانٍ واحد، يسرقونني عوضًا عن أيّ واحدٍ من إخوتي ويضعونني في خرج حمارٍ هزيلٍ ويصبغون غرّتي.
ضحكت بأعلى صوتي حين تذكّرت تلك الأماسي الرائعة، حتّى انتبه المراجعون في صالة الانتظار.
انفتح باب الموظّفة الشقراء مرّةً أخرى، أسرعت إليها، لكن هذه المرّة بابتسامةٍ عريضةٍ ملأتْ الغرفة، فاستغربتْ من عودتي سعيدًا بعد خروجي المتذمّر... صافحتُها باليد واعتذرتُ عن الطريقة الغبيّة الّتي ناقشتُ بها دون وعيٍ تلك الحروف الثلاث (XXX) على بطاقتي، وتمنّيتُ عليها أن تحدّثني لاحقًا كيف أبحرتْ مع صديقها على صفحة بحيرة «بودن زي» الّتي لم يمش المسيح عليها بجوربيه.
نظرتْ إليّ باستغرابٍ شديد، بينما خلعتُ حذائي ورحتُ أرقص في الشارع فوق نقع الماء وأغنّي لثقب الأوزون الّذي سدّه أصدقائي ذات يوم.
راكان حسين - كاتب فلسطينيّ مقيم في ألمانيا.